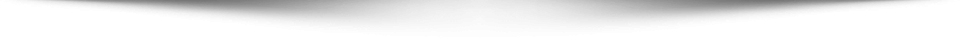يعكف الباحثون على وضع مجموعةٍ من السيناريوهات لتوقُّع المشهد في السنوات القليلة القادمة.
تخيَّل أنَّك الآن في شهر يونيو من عام 2021، وأنَّ العالَم قضى عامًا ونصف العام يرزح تحت وطأة جائحة فيروس كورونا، وما زال الفيروس ينتشر بوتيرةٍ بطيئة، وأصبح المعتاد هو أن تُطبَّق تدابير الإغلاق من حينٍ إلى آخر. ومع أنه صار لدينا لقاحٌ مُعتمَد، يُكسِبنا الحماية من الفيروس لمدة ستة أشهر، فإنَّ توزيعه قد تأخَّر بسبب صفقات تعقدها الدول بين بعضها بعضًا. وقد أُصيبَ بالفيروس ما يُقدَّر بمائتين وخمسين مليون شخص حول العالم، وتُوفِّيَ 1,75 مليون مصاب من جرائه.
تتوقع السيناريوهات المماثلةُ التطورات المحتملة لجائحة “كوفيد-19”1. ففي جميع أنحاء العالم، يعكف علماء الوبائيات على وضع توقعاتٍ للمدى القصير للجائحة، وكذلك للمدى الطويل لها، وذلك للاستعداد لمواجهة انتشار فيروس “سارس-كوف-2” المُسبِّب لمرض “كوفيد-19″، والآثار الناجمة عنه، وربما للنجاح أيضًا في تخفيف انتشاره وآثاره. ورغم اختلاف توقعات واضعي النماذج، والأطر الزمنية التي يخرجون بها، إلا أنهم يتفقون على أمرين، أولهما: أنَّ مرض “كوفيد-19” سيستمر في الانتشار لوقتٍ طويل، وثانيهما: أنَّ المستقبَل مرهونٌ بكثيرٍ من العوامل المجهولة، منها ما إذا كان البشر سيطورون مناعةً طويلة المدى تجاه الفيروس، أم لا، وما إذا كان انتشاره يتأثر بتغيُّر فصول السنة، أم لا. وهناك عاملٍ آخر، ربما يكون الأكثر أهمية، وهو الخيارات التي تتخذها الحكومات والأفراد. وعن ذلك، تقول روزاليند إيجو، خبيرة نمذجة الأمراض المُعْدية في كلية لندن للصحة والطب المداري (LSHTM): “ثمة عددٌ كبير من المناطق يُنهِي حاليًّا تدابير الإغلاق، وهناك عددٌ كبير أيضًا مستمر في تطبيقها. ولا نعرف حقًّا ماذا سيحدث”.
ويضيف جوزيف وو -خبير نمذجة الأمراض في جامعة هونج كونج- قائلًا: “سيعتمد المستقبل اعتمادًا كبيرًا جدًّا على درجة الاختلاط الاجتماعي التي سنعود إليها، وعلى سبل الوقاية التي نتبعها”. وفي هذا الصدد، تشير النماذج والأدلة الحديثة، المُستقاة من تجارب الإغلاق الناجحة، إلى أنَّ التغيرات السلوكية يمكنها أن تقلل من انتشار مرض “كوفيد-19″، إذا تبنَّاها معظم الناس، وليس بالضرورة جميعهم.
ويُذكر أنه في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بالمرض 15 مليون إصابة على مستوى العالم، ووصل عدد الوفيات إلى حوالي 650 ألف حالة. وقد بدأت بلدان عديدة في تخفيف تدابير الإغلاق، ودفع هذا بعض الناس إلى افتراض أنَّ الجائحة أضحت في نهايتها، حسبما أوضح يوناتان جراد، عالِم الوبائيات في كلية هارفارد تي. إتش. تشان للصحة العامة في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية، الذي أضاف: “لكنَّ هذا اعتقاد يجافي الصواب. فما زال أمامنا طريقٌ شاق وطويل”.
وعلى سبيل المثال، إذا استمرت المناعة تجاه الفيروس لمدةٍ تقل عن عام، كما يحدث في حال فيروسات كورونا الأخرى السارية بين البشر، فربما نشهد زياداتٍ سنوية حادة في أعداد حالات الإصابة بمرض “كوفيد-19″، تستمر إلى عام 2025، وبعده. لذا، في هذا التحقيق الإخباري، تستعرض دورية Nature توقعات العِلْم للوضع في الأشهر والسنوات القادمة.
ماذا يحمل لنا المستقبل القريب؟
تختلف تطورات الجائحة من مكانٍ إلى آخر. وهناك دول -مثل الصين، ونيوزيلندا، ورواندا- تمكنت من خفْض أعداد الحالات بها بعد تطبيق تدابير الإغلاق لمددٍ متفاوتة، وتُخفِّف هذه البلدان حاليًّا القيود التي فرضتها، بينما تتابِع الوضع تحسبًا لوقوع أيّ ارتفاع مفاجئ في انتشار المرض، بيد أنه في دولٍ أخرى -مثل الولايات المتحدة، والبرازيل- تشهد أعداد الحالات زيادةً سريعة في الوقت الحالي، بعد أن أنهت حكومات بعض تلك الدول سريعًا تدابير الإغلاق التي كانت تطبقها، أو لأنَّ بعضها الآخر لم يُطبق هذه التدابير من الأساس على الصعيد الوطني.
وهذه المجموعة الأخيرة من الدول تثير قلقًا بالغًا لدى خبراء النمذجة. وعلى سبيل المثال، في جنوب أفريقيا، التي تحتل الآن المرتبة الخامسة على مستوى العالم بين الدول الأعلى من حيث العدد الإجمالي لحالات المرض فيها، يُقدِّر اتحادٌ من واضعي النماذج2 أنَّ البلد يمكنه توقُّع حدوث ذروةٍ في عدد حالات الإصابة بالمرض فيه في شهر أغسطس، أو سبتمبر، ليصل عدد الحالات النشطة إلى حوالي مليون حالة، وبحيث يصل العدد التراكمي للحالات التي تظهر عليها الأعراض إلى 13 مليون حالة بحلول أوائل شهر نوفمبر. وفيما يتعلق بموارد مستشفيات هذا البلد، تقول جولييت بوليام، مديرة مركز جنوب أفريقيا للنمذجة والتحليلات الوبائية في جامعة ستيلينبوش: “نتجاوز حاليًّا بالفعل القدرة الاستيعابية للمستشفيات في بعض المناطق. ولذا، أعتقد أنَّ أفضل سيناريو يمكن توقعه في حالتنا ليس جيدًا”.
لكن هناك أنباءٌ تبعث على التفاؤل مع تخفيف حدة تدابير الإغلاق، إذ تشير الأدلة الأولية إلى أنَّ التغيرات في السلوكيات الشخصية، مثل غسل اليدين، وارتداء الكمامات، ما تزال مستمرةً، حتى بعد إنهاء تدابير الإغلاق المُشدَّدة، وتساعد بهذا على كبح زيادة الإصابات. ففي تقريرٍ3 صدر في شهر يونيو الماضي، وجد فريقٌ بحثي يعمل في مركز “إم آر سي” لتحليلات الأمراض المعدية العالمية -التابع لجامعة إمبريال كوليدج لندن- أنَّه من بين 53 دولة بدأت بالفعل تخفيف تدابير الإغلاق، لم تشهد أي دولةٍ زيادة كبيرة في عدد الإصابات كما كان متوقعًا على أساس البيانات السابقة. وأوضح سمير بهات، عالِم الوبائيات المتخصص في الأمراض المعدية بجامعة إمبريال كوليدج لندن، وأحد المؤلفين المشاركين في إعداد هذا التقرير، قائلًا: “لقد أُبخس تقدير مدى تغيُّر سلوكيات الأفراد، من ناحية ارتداء الكمامات، وغسل اليدين، والتباعد الاجتماعي، إذ لم تعد تلك السلوكيات كما كانت من قبل على الإطلاق”.
والباحثون في بؤر انتشار الفيروس يدرسون مدى جدوى هذه السلوكيات. ففي جامعة أنيمبي مورومبي، الواقعة بمدينة ساو باولو في البرازيل، عكف على دراسة هذه السلوكيات الباحث أوسمار بينتو نيتو، المتخصص في علم البيولوجيا الحوسبية، إذ أجرى مع زملائه عمليات محاكاة بأكثر من 250 ألف نموذج رياضي لاستراتيجياتٍ خاصة بالتباعد الاجتماعي، تُوصف بأنَّها إمّا تُطبَّق باستمرار، أو على نحوٍ متقطع، أو أنَّ تطبيقها يتراجع تدريجيًّا، إلى جانب تدخلاتٍ سلوكية، مثل ارتداء الكمامات، وغسل اليدين، مع تخفيف القيود المفروضة تدريجيًّا في عمليات المحاكاة.
وخلُص الفريق إلى أنَّه إذا التزمت نسبةٌ تتراوح بين 50%، و65% من الناس بالحذر في الأماكن العامة، فإنَّ تخفيف تدابير التباعد الاجتماعي المُطَّبقة كل 80 يومًا قد يساعد على منع حدوث المزيد من حالات ذروة تفشي الفيروس على مدار العامين القادمين. ويقول نيتو: “سنحتاج إلى تغيير ثقافة التعامل مع الآخرين”. ويضيف قائلًا: “إجمالًا، من المُبشِّر أن نَعْلَم أنَّ السلوكيات يمكنها أن تُحدِث فارقًا كبيرًا في انتشار المرض، حتى بدون إجراء الفحوص، أو استخدام اللقاحات”.
وهذه المفاضلة بين تدابير الإغلاق وإجراءات الوقاية الشخصية درسها أيضًا الباحث خورخي فيلاسكو هيرنانديز، خبير نمذجة الأمراض المعدية من جامعة المكسيك الوطنية المستقلة في مدينة جوريكويلا، متعاونًا في ذلك مع زملائه. ووجدوا أنَّه إذا التزم 70% من سكان المكسيك بإجراءات الوقاية الشخصية، مثل غسل اليدين، وارتداء الكمامات، في أعقاب عمليات الإغلاق الطوعية التي بدأت في أواخر مارس، فإنَّ تفشي الفيروس في البلاد سيتراجع بعد وصوله إلى ذروته في أواخر مايو، أو أوائل يونيو5. لكنَّ حكومة المكسيك أنهت تطبيق تدابير الإغلاق في الأول من يونيو، وثبت المعدل المرتفع للوفيات الأسبوعية الناجمة عن مرض “كوفيد-19″، بدلًا من أن يتراجع. ويرى فريق هيرنانديز أنَّ هناك عطلتَين رسميتَين انتشر فيهما الفيروس على نحوٍ فائق، وتسببتا في ارتفاع معدلات العدوى قبيل إلغاء الحكومة للقيود المفروضة.
أما بالنسبة إلى المناطق، التي يبدو أنَّ المرض ينحسر فيها، فيقول الباحثون إنَّ أفضل نهجٍ يمكن تطبيقه هو متابعة الوضع بعناية، عن طريق إجراء الفحوص، وعزل الحالات الجديدة، وتتبع مخالطيها. وهذا هو الوضع في هونج كونج، على سبيل المثال، إذ يقول وو: “نُجري حاليًّا التجارب، ونسجل الملاحظات، ونُعدِّل أساليبنا ببطء”. ويَتوقع وو أن تمنع هذه الاستراتيجية حدوث زيادةٍ كبيرة في أعداد حالات الإصابة، إلا إذا جلبت الزيادة في حركة النقل الجوي عددًا كبيرًا من الحالات من خارج البلاد.
والسؤال المطروح الآن، إلى أيّ مدى يلزم تتبع المخالطين، وعزل المصابين، كي يمكن احتواء تفشي المرض بفعالية؟ للإجابة عن هذا السؤال، عكفت مجموعة العمل المعنية بمرض “كوفيد-19” في مركز النمذجة الرياضية للأمراض المعدية -التابع لكلية لندن للصحة والطب المداري- على إجراء تحليلٍ7 يحاكي موجات تفشي جديدة للمرض، تختلف فيما بينها في درجة انتشار العدوى، وتبدأ إما بخمس حالاتٍ وافدة من خارج البلد، أو بعشرين، أو بأربعين حالة. وخلُص الفريق إلى أنَّ تتبع المخالطين يجب أن يتسم بالسرعة والشمول لاحتواء موجات التفشي، بمعنى تتبع 80% من المخالطين في غضون بضعة أيام. وتقول إيجو، التي شاركت في تأليف الورقة الخاصة بذلك التحليل، إنَّ المجموعة تُقيِّم الآن فعالية أساليب تتبُّع المخالطين باستخدام الأجهزة الإلكترونية، والمدة المناسبة لعزل مَن تعرضوا للفيروس في الحجر الصحي. وتضيف قائلة: “من المهم حقًّا موازنة الاستراتيجية التي نطبقها بين كونها مقبولةً بالفعل للناس، وبين كونها قادرةً على احتواء تفشي المرض”.
وقد يكون من شبه المستحيل تتبُّع 80% من المخالطين في المناطق التي ما زالت تواجه آلاف الإصابات الجديدة كل أسبوع. والأدهى من ذلك، أنّ حتى أعلى تقديرات أعداد الحالات المُسجَّلة تقل -على الأرجح- عن الأعداد الفعلية. وحسب ما أفادت به دراسةٌ تُحلِّل البيانات الخاصة بفحوص مرض “كوفيد-19” في 84 دولة، أجراها فريقٌ تابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في مدينة كامبريدج، ونُشِرَت مسودةٌ أولية1 من ورقتها البحثية في يونيو الماضي، فإنَّ عدد حالات الإصابة الفعلية على مستوى العالم كان أكبر بمقدار 12 مرة من العدد المُسجَّل رسميًّا، كما كان عدد الوفيات أعلى بنسبة 50%. وعن ذلك، يقول جون ستيرمان، المؤلف المشارك في الدراسة، ومدير مجموعة ديناميات الأنظمة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: “عدد الحالاتِ يفوق بكثير ما تفيد به البيانات. ونتيجةً لذلك، فإنَّ خطر العدوى أكبر بكثير مما قد يعتقده الناس”.
ومن ثم، يقول بهات إنَّه في الوقت الحالي، هناك حاجة إلى مواصلة الجهود الهادفة إلى كبح انتشار المرض لأطول فترةٍ ممكنة، مثل تدابير التباعد الاجتماعي، وذلك لتجنُّب حدوث موجة تفش ثانية كبيرة. وأوضح هذا قائلًا: “أي حتى حلول أشهر الشتاء، التي من المتوقع أن يصبح الوضع فيها أكثر خطورةً بعض الشيء من جديد”.
ماذا عن الشتاء؟
أصبح من الواضح الآن أنَّ فصل الصيف لا يُوقِف انتشار الفيروس على النحو ذاته بجميع المناطق، لكنَّ الطقس الدافئ قد يُسهِّل احتواءه في المناطق معتدلة المناخ. أمَّا المناطق التي ستزداد برودة مناخها في النصف الثاني من العام الجاري 2020، فيعتقد الخبراء أنَّها ستشهد -على الأرجح- زيادةً في انتشار العدوى. ففيروسات عديدة من تلك التي تصيب الجهاز التنفسي للبشر، مثل الإنفلونزا، وفيروسات كورونا الأخرى، والفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، تتغير قدرتها على الانتشار بتغيُّر فصول السنة، وهذه التغيرات تؤدي إلى تفشيها في الشتاء، ولذلك من المحتمل أن يحذو فيروس “سارس-كوف-2” حذو تلك الفيروسات.
تقول أكيكو إيواساكي، اختصاصية علم بيولوجيا المناعة بكلية ييل للطب في مدينة نيو هايفن بولاية كونيتيكت الأمريكية: “أتوقع أن يرتفع معدل عدوى فيروس “سارس-كوف-2″ في الشتاء، وأن تزداد كذلك حدة آثاره المرضية على الأرجح”. وتضيف قائلة إنّ الأدلة تشير إلى أنَّ هواء الشتاء الجاف يعزز استقرار فيروسات الجهاز التنفسي8 وقابلية انتقالها، كما أنَّ الدفاعات المناعية في مجرى التنفس ربما يصيبها الضعف، نتيجة استنشاق الهواء الجاف.
وبالإضافة إلى ذلك، يميل الناس في المناطق ذات الطقس الأبرد إلى البقاء داخل منازلهم، حيث يزداد خطر انتقال عدوى الفيروس عبر القطيرات، حسبما أوضح ريتشارد نيهر، اختصاصي علم البيولوجيا الحوسبية من جامعة بازل في سويسرا. وتُظهِر عمليات المحاكاة التي أجرتها مجموعة نيهر أنَّ تغيرات الفصول من المرجح أن تؤثر على انتشار الفيروس، وربما تزيد من صعوبة احتوائه في نصف الكرة الشمالي خلال هذا الشتاء9.
ومن المحتمل أيضًا في المستقبل أن يضربنا تفشي الفيروس في صورة موجاتٍ تحل كل شتاء. وكما هو الحال مع الإنفلونزا، فالبالغون الذين أُصيبوا بالمرض بالفعل قد يقل خطر إصابتهم بالعدوى، لكنَّ ذلك سيعتمد على مدى سرعة زوال المناعة المكتسبة ضد هذا الفيروس، وذلك وفقًا لما ذكره نيهر. وإضافةً إلى ذلك، قد يكون من الصعب التعامل مع مزيج أمراض “كوفيد-19″، والإنفلونزا، والفيروس المخلوي التنفسي في فصلي الخريف والشتاء، حسبما يعتقد هيرنانديز، الذي يعكف حاليًّا على وضع نموذج للكيفية التي من الممكن أن تتفاعل بها هذه الفيروسات مع بعضها بعضًا.
كما أنَّنا ما زلنا لا نعلم ما إذا كانت الإصابة بفيروسات كورونا الأخرى التي تصيب البشر يمكن أن تُكسِبنا أي حمايةٍ من فيروس “سارس-كوف-2″، أم لا. ففي تجربة استزراعٍ خلوي درست هذا الفيروس وفيروس “سارس-كوف” القريب سلاليًّا منه، أمكن للأجسام المضادة الناتجة عن الإصابة بأحدهما أن ترتبط بالآخر، لكنَّها لم تؤدِ إلى تعطيله، أو تحييده10.
ولوضع حدّ للجائحة، يجب إمَّا القضاء على الفيروس في جميع أنحاء العالم -وهو أمرٌ يجمِع معظم العلماء على أنَّه يكاد يكون مستحيلًا، بالنظر إلى مدى انتشاره- أو أن يكتسب الناس مناعةً كافية تجاهه من خلال العدوى أو التطعيم. وتشير التقديرات إلى أنَّ تحقيق هذا يتطلب أن يكتسب تلك المناعة ما يتراوح بين 55%، و80% من الناس، حسب كل بلد11.
ولسوء الحظ، تشير المسوح الأولية إلى أنَّه ما زال أمامنا شوط طويل لنقطعه في هذا الصدد، إذ تُبيِّن التقديرات القائمة على فحوص الأجسام المضادة، التي تكشف ما إذا كان الأفراد قد تعرضوا للإصابة بالفيروس وكوَّنوا الأجسام المضادة له، أم لا، أنَّ نسبةً صغيرة فقط من الناس قد أُصيبت بالعدوى. وهذا الاستنتاج تدعمه نماذج انتشار المرض، إذ قَدَّرت دراسةٌ أُجريت على 11 دولة أوروبية أنَّ نسبة الإصابة بالمرض تراوحت بين 3%، و4% حتى الرابع من مايو الماضي12، وذلك استنادًا إلى البيانات الخاصة بمعدلات الإصابة بالمرض، وعدد الوفيات التي وقعت حتى ذلك الحين. وفي الولايات المتحدة، التي شهدت وقوع أكثر من 150 ألف حالة وفاة بالمرض، وجد مسحٌ شمل الآلاف من عينات مصل الدم، وجرى بتنسيقٍ من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنَّ انتشار الأجسام المضادة بين السكان تراوحت نسبته بين 1%، و6.9%، حسب المنطقة13.
ماذا سوف يحدث في عام 2021، وما بعده؟
سوف يعتمد مسار الجائحة في العام المقبل اعتمادًا كبيرًا على توفر لقاح، وعلى مدة استمرار الحماية التي يوفرها الجهاز المناعي للجسم بعد التطعيم، أو التعافي من العدوى. إنَّ كثيرًا من اللقاحات يوفر الحماية للإنسان لعقودٍ من الزمن، مثل اللقاحات المضادة للحصبة، وشلل الأطفال، في حين أنَّ البعض الآخر -مثل لقاحات السعال الديكي، والإنفلونزا- يزول أثره بمرور الوقت. وبالمثل، فإنَّ أنواعًا من العدوى الفيروسية تُكسِب الجسم مناعةً طويلة المدى تجاهها. أما بعضها الآخر، فيثير استجابةً مناعية مؤقتة. وفي هذا الشأن جاء في ورقة بحثية14 تستكشف السيناريوهات المحتملة، نُشرت في شهر مايو الماضي، وألَّفها كل من يوناتان جراد، ومارك ليبسيتش عالِم الوبائيات بجامعة هارفارد، وزملاؤهما: “سوف يعتمد إجمالي عدد الإصابات بفيروس “سارس-كوف-2″ خلال عام 2025 اعتمادًا كبيرًا على مدة استمرار المناعة المكتسبة تجاهه” (انظر: “توقعات الفترة القادمة”).
ولا يعرف الباحثون حتى الآن سوى القليل عن مدة استمرار تلك المناعة، فقد وجدت إحدى الدراسات15 المُجراة على بعضٍ ممن تعافوا من المرض أنَّ الأجسام المضادة المُحيِّدة للفيروس استمرت لمدةٍ تصل إلى أربعين يومًا من بدء العدوى. ويشير العديد من الدراسات الأخرى إلى أنَّ مستويات الأجسام المضادة تتراجع تدريجيًّا بعد أسابيع أو شهور. وإذا اتبع “كوفيد-19” نمطًا مشابهًا لمرض “سارس”، فقد تظل مستويات الأجسام المضادة مرتفعةً لمدة خمسة أشهر، وتتراجع ببطء على مدى فترةٍ تتراوح من عامين إلى ثلاثة أعوام16، لكنَّ إنتاج الأجسام المضادة ليس هو الصورة الوحيدة للحماية المناعية؛ إذ إن الخلايا الذاكرة البائية والتائية تحمي الجسم أيضًا في مواجهاته المستقبلية مع الفيروس، ولا يُعرَف سوى القليل حتى الآن عن دورها في مواجهة عدواه. وللحصول على إجابةٍ واضحة بشأن مسألة المناعة هذه، سوف يحتاج الباحثون إلى متابعة عددٍ كبير من الأشخاص على مدار فترةٍ زمنية طويلة، حسبما أوضح مايكل أوسترهولم، مدير مركز بحوث الأمراض المعدية وسياساتها (CIDRAP) بجامعة مينيسوتا في مدينة مينيابولس الأمريكية. وأضاف أوسترهولم قائلًا: “ما علينا سوى الانتظار”.
وإذا استمرت أعداد الحالات في الارتفاع بسرعةٍ، دون وجود لقاحٍ أو مناعةٍ طويلة المدى، يرى جراد أنَّنا “سنشهد سريانًا منتظمًا وواسع النطاق للفيروس”. وفي تلك الحالة، سيصبح الفيروس متوطِّنًا، حسبما أوضحت بوليام، التي أضافت قائلة: “سيكون ذلك فاجعًا حقًّا”. وهذه الاحتمالية ليست بعيدةً عن التصور، فمرضٌ مثل الملاريا، الذي يمكن الوقاية منه وعلاجه، يقتل أكثر من 400 ألف شخص سنويًّا. ويوضح بهات هذا بقوله: “أسوأ السيناريوهات المتوقعة تحدث في كثيرٍ من البلدان في حال أمراضٍ يمكن الوقاية منها، وهو ما يسبب بالفعل خسائر فادحة في الأرواح”.
وحسبما يشير فريق جامعة هارفارد، إذا كان الفيروس يحفز مناعةً قصيرة الأمد في جسم الإنسان، على غرار فيروسين آخرَين من فيروسات كورونا التي تصيب البشر، وهما OC43، وHKU1، اللذان تستمر المناعة ضدهما لمدة 40 أسبوعًا تقريبًا، فمن الممكن إذن أن يُصاب الناس بالعدوى مجددًا، وأن نشهد تفشيًا سنويًّا للمرض. وفي هذا الصدد، يشير تقريرٌ تكميلي صادر عن مركز بحوث الأمراض المعدية وسياساتها17، يستند إلى الاتجاهات المستنبطة من ثماني جوائح عالمية لمرض الإنفلونزا، إلى أنَّنا قد نشهد نشاطًا كبيرًا ملحوظًا لمرض “كوفيد-19” في الفترة المقبلة، لمدةٍ تتراوح ما بين 18 و24 شهرًا على الأقل، إمَّا في صورة سلسلةٍ من أحداث الذروة والانحسار، تتراجع حدتها تدريجيًّا، أو في صورة “موجة بطيئة” من الانتشار المستمر، ليس لها نمطٌ واضح. ومع ذلك، تظل هذه السيناريوهات مجرد تخمينات، لأنَّ هذه الجائحة لم تسر حتى الآن وفق نمط الإنفلونزا الجائحة، حسبما أوضح أوسترهولم، الذي أضاف قائلًا: “نحن نواجه جائحةً لفيروس تاجي، لم نشهد مثلها من قبل”.
وثمَّة احتمالية أخرى، هي أن تكون المناعة ضد الفيروس دائمة. وفي تلك الحالة، فحتى بدون توفر اللقاح، من الممكن للفيروس أن يستنزف نفسه، ويختفي بحلول عام 2021، بعد أن يجتاح تفشيه العالَم، لكن إذا كانت المناعة متوسطة الأمد، بمعنى أنها تستمر لمدة عامين تقريبًا، فحينئذٍ قد يبدو كما لو أنَّ الفيروس قد اختفى، لكَّن انتشاره يمكن أن يزيد مجددًا زيادةً حادة مفاجئة في عام 2024، حسبما تبيَّن لفريق جامعة هارفارد.
لكنَّ هذه التوقعات لا تأخذ في الاعتبار احتمالية تطوير لقاحاتٍ فعالة للمرض. وهذا أمرٌ غير مستبعد، بالنظر إلى القدر الكبير من الجهد والمال المبذولَين لذلك الغرض، وإلى حقيقة أنَّ بعض اللقاحات المُحتمل نجاحها يجري اختباره بالفعل على البشر حاليًّا، حسبما أوضح هيرنانديز، إذ تشير منظمة الصحة العالمية إلى أنَّ هناك 26 لقاحًا يُجرَّب على البشر في الوقت الراهن، منها 12 لقاحًا وصلت إلى تجارب المرحلة الثانية، بينما وصل إلى تجارب المرحلة الثالثة ستة لقاحات. وحتى في حال تطوير لقاحٍ يوفر حمايةً غير تامة من المرض، فإنَّ ذلك من شأنه أن يساعدنا عن طريق تخفيف حدته، والحيلولة دون إيداع المرضى بالمستشفيات، حسبما يرى وو. ومع ذلك، سوف يستغرق الأمر عدة أشهر، حتى نطور لقاحًا فعَّالًا، ونوزعه.
ولن تتأثر مناطق العالم المختلفة بمرض “كوفيد-19” بالدرجة نفسها، إذ ترى إيجو أنَّ المناطق ذات المجموعات السكانية الأكبر أعمارًا يمكن أن تشهد عددًا أكبر من الحالات، مقارنةً بغيرها، في المراحل اللاحقة من الوباء. وفي هذا الصدد، أوضح نموذجٌ رياضي، أعدّه فريق إيجو، ونُشر في شهر يونيو الماضي18، استنادًا إلى بياناتٍ خاصة بستة بلدان، أنَّ احتمالية الإصابة بالعدوى لدى الأطفال ومَن تقل أعمارهم عن عشرين عامًا تبلغ تقريبًا نصف احتمالية إصابة البالغين الأكبر سنًّا.
وثمة أمرٌ واحد مشترك بين كل الدول والمدن والمجتمعات التي أصابتها الجائحة، وهو –حسب قول بوليام- أنَّنا “ما زلنا نجهل الكثير جدًّا عن هذا الفيروس. وإلى أنْ تتوفر لدينا بياناتٌ أفضل، سيظل الوضع مبهمًا إلى حدٍّ كبير”.
المصدر:https://arabicedition.nature.com/journal/2020/09/d41586-020-02278-5/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%8E%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF